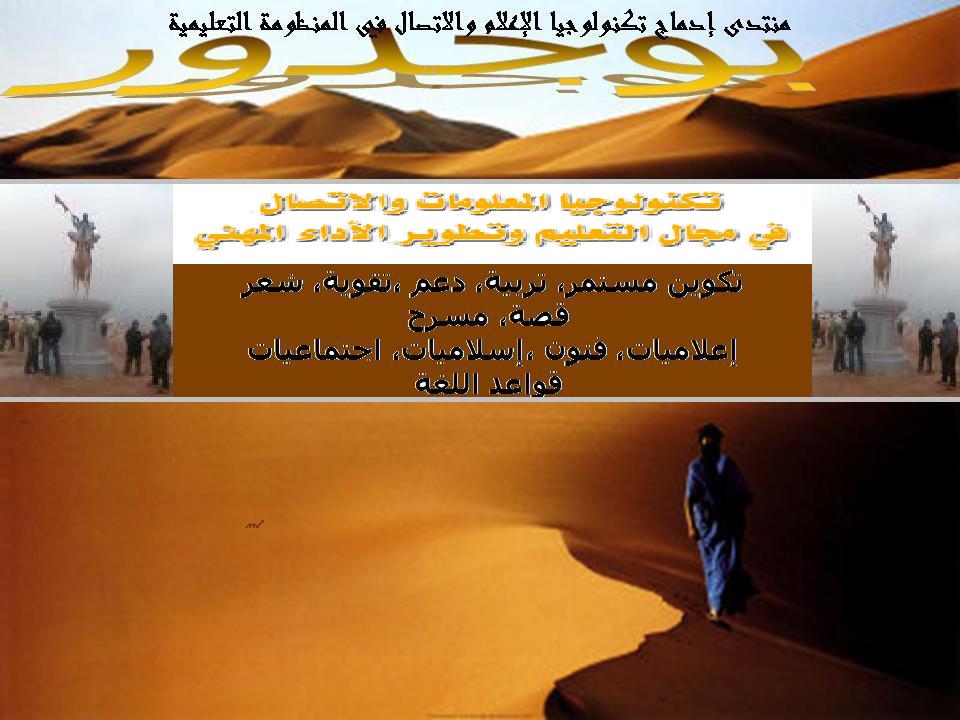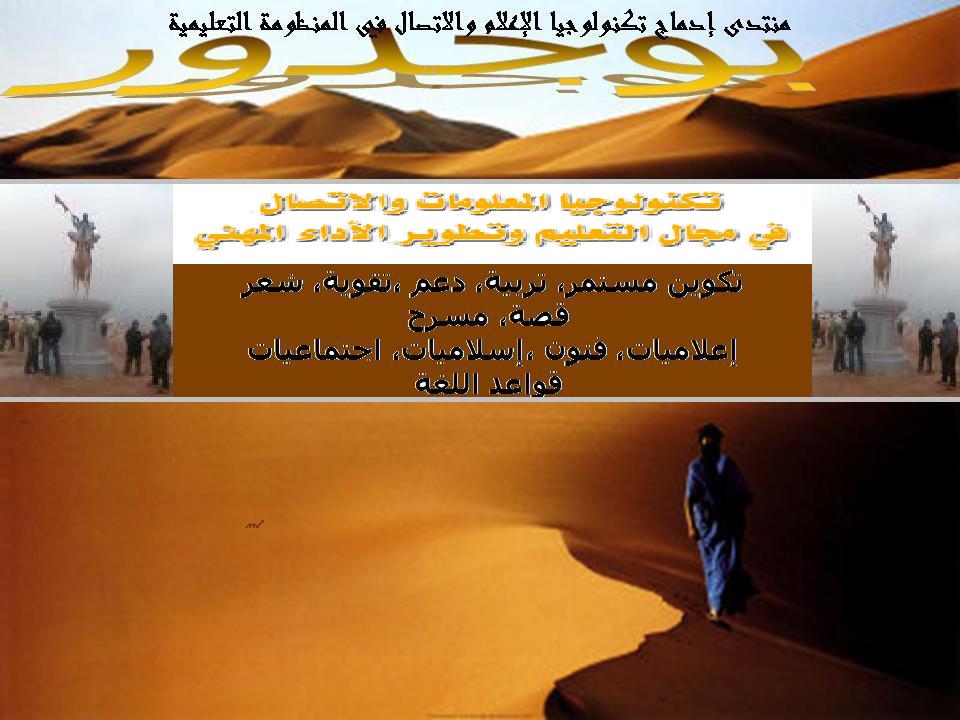
منتدى فريق جيني بوجدور
التربية والتعليم
|
|
| | الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام -تتمة1- |  |
| | | كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
أبوعمر
Admin
عدد المساهمات : 81
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمر : 46
الموقع : www.genieboujdour.123.st
 |  موضوع: الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام -تتمة1- موضوع: الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام -تتمة1-  السبت 15 يناير 2011, 11:02 am السبت 15 يناير 2011, 11:02 am | |
| ثانياً: السلبية لغة ودلالة:
لغة:
السّلب هو الشيء أخذه من غَيْره قهراً؛ هذا في المعاجم العربية، لكن اللفظة، كما نهدف إليها غير موجودة في هذه المعاجم شأنها شأن الإيجابيّة. والموجود لها المصدر الصّناعي السّلبيّة، ولكن معاجم لغات أخرى توضحها أكثر.
فقد جاءت في المعاجم الإنكليزية على أنها (Negativesm) وتعني السلبية كأن يطلب إلى مريض الخلود إلى الراحة والابتعاد عن نوع معيّن من الطعام، لكنه لا يتقيد بما طلب منه، فيكون موقفه سلبياً.
ولما كان يُطلب إلى الشاعر احترام شاعريته وتفجير ينابيع الخير والعطاء السليم منها، فقد اعتبرنا عدم تقيده بما يطلب منه أمراً سلبياً. ولها معان عدة تشترك فيها النظريات الفلسفية والتعليمية والسياسية أيضاً، وها نحن نثبتها في الأدب( ) كذلك. فهناك ما يقال له: (Negatite Adataion) أي التكيف السلبي ويقولون (Negative attitude) بمعنى الموقف السلبي، وهناك التحول السلبي: (Positive Trausfer) يقابل التحول الإيجابي.
ونستطيع أن نقول( ) : (Poetry Negative) أي الشعر السلبي. ويبقى المصطلح الإنكليزي الذي اشتقّت منه تسميات وإضافات عدة: (Negativism) هو الأصل المعتمد، والمصدر الرئيسي للكلمة. ولابد من التنويه بلغات أوربية أخرى تستخدم هذه الكلمة بهذا المعنى، كالفرنسية، والألمانية، و الإسبانية.
دلالة:
لعلنا في التعريف اللغوي تطرقنا إلى الدلالة التي تمليها هذه الكلمة. ولابد من التوسع في الحديث عما تدل عليه هذه اللفظة كما يرسم البحث خطتها( ) .
إذا بحثنا عن موقف ما لشاعر ما، من مفهوم ما، وكان الموقف مناسباً، قلنا عنه: إنه موقف إيجابي. وإن لم نجد الموقف المناسب من هذا المفهوم، قلنا عنه: إنه موقف سلبي. وعلى هذا فدلالة السلبية هنا على ملتقى طريق مع المنطق، وهي أن نحكم على شيء بعدم وجود آخر فيه.
كأن يذكر التاريخ عهداً انتشر فيه الظلم والتعسف، ونبحث في الشعر الذي صدر في ذلك العهد عن صورة لتلك المظالم، فلا نجد لها أثراً فيه. ولا نجد من يفضح الظلم والتعسف الذي كان في ذلك العهد أو يندد بالفساد والاستعباد.
والشعر الذي لا توجد فيه بواعث القيم والأخلاق، ولا يحتوي إلا المعنى المبتذل الساقط، أو المعنى الفاسد. لا يدل عليه إلا مصطلح السلبية.
والشعر الذي يثير المنازعات على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات، ويعمل على إثارة الفتن والاضطرابات، والسفه والطيش والنزق، شعر سلبي.
ويدل المصطلح السلبي على الشعر الذي يتناول الخرافات والأوهام مؤمناً بها، جاعلاً منها نظريات في العقيدة، ضمن متاهات فكرية وأحاديث خرافية تتحكم بمصير الإنسان ومآله في هذه الحياة، من طيرة، وأوهام وتشاؤم، وأمور أخرى تسلب إرادة الإنسان وتجعله تابعاً في مدار الخرافات، كما تظهر ملامحه في الكذب والقلق والضلال( ) .
وليس ثمة تعريف جامع مانع لأن قضية التعاريف ليست قضية قطعية وربما كان التعريف زئبقياً أحياناً لا يقف عند أمر قطعي. ومثالنا على ذلك اصطلاح الواقعية التي أوصلها بعضهم إلى معان كثيرة تجاوزت المائة فمن المصطلحات التي ذكرها "داميال غرانك" للواقعية مثيراً إلى تعدد فروعها وتشعب أشكالها: "الواقعية الانتقادية، الواقعية المستمرة، الواقعية الدينامية، الواقعية الخارجية، الواقعية المثالية، الواقعية الخيالية، الواقعية الشكلية، الواقعية الساخرة، الواقعية القاتلة، الواقعية الساذجة، الواقعية العرضية، الواقعية الوطنية.. الخ( ) . ومانستطيع التسليم به هنا، هو ما ذكرناه من دلالة، المصطلحين الإيجابية والسلبية فإن ما يقلق القارئ عنهما، هو المشروعية الفنية لصياغة هذين المصطلحين.
ولكننا هنا نحاول أن نكون بعيدين عن مسألة التراكم في أبحاث التراث، "وأحد وجوه هذه المسألة هو هذا التعميم في المصطلح النقدي، وفي اللفظ( ) ...".
مدلول الكلام عامة:
لا يستغني باحث عن أصل الألفاظ، وذلك لدلالتها على المعاني. وحين نريد الوقوف على أصل هذين المصطلحين (الإيجابية والسلبية) اللذين نعتبرهما السكة المزدوجة تحمل كل واحدة منهما بضاعة مخالفة لما تحمله الأخرى، حين نريد ذلك يجب أن نتذكر التطور الذي يحدث في الكلمة تبعاً لتطور الشؤون المحيطة بهذا المدلول.
وحين يحدث تطور من هذا القبيل فإنه يعطي الكلمة وجهة خاصة بها فكلمة سلبي (Negative) تستخدم كثيراً في بحوث علم النفس والمنطق ونستطيع أن نراقب تطورها في المواقف التي يتخذها الشعراء من المفاهيم، لنرى أنها كانت في المنطق تعني الحكم على شيء بعدم وجود آخر فيه( ) ، فأصبحت في الأدب تعطي المدلول. السابق مع تطور الكيفيّة.
وكلمة إيجابي "Positve" أو "Affirmatif”( ) في المنطق تدل على القضية الموجبة، وهي أن تحكم على شيء بوجود آخر فيه أصبحت في الأدب كما بينّاها في المدلول الذي وضحناه مع تطور الكيفية أيضاً.
إن اللغة كان حي يخضع للتطور والنمو والانقراض، وربما كان من المنطقي أن نقول: إن تكرار وكثرة استعمال كلمة ما، في معنى ما، يؤدي غالباً إلى انقراض المعنى الحقيقي لتلك الكلمة، ليحل محلها المعنى الجيد.
ولن يضير اللغة العربية أن تعتمد هذين المصطلحين في الأدب، فالتعريب هو أحد( ) العوامل التي تنمي اللغة. ولنا في الأولين من العرب أسوة( ) حسنة. فقد أخذوا ألفاظاً كثيرة من الأمم المجاورة، فأدخلوها على لغتهم. وهذا ليس شأن اللغة العربية فحسب، وإنما هو أمر تشترك فيه لغات العالم كلها، وينجم عن احتكاك الأمم ببعضها، ولاسيما في هذا العصر حيث صغرت الكرة الأرضية مئات المرات، وتقاربت شعوب الأرض، دون أن يتقلص حجم الكرة ولو بمقدار!. إنها مواصلات العصر، وسمته العمليّة وكثرة احتكاك أمم الأرض ببعضها.
ولاشك أن مدلول السلبية أو الإيجابية يختلف من عصر إلى عصر. فما كان سلبياً في العصر الجاهلي، قد يكون إيجابياً في العصر الإسلامي. وما كان إيجابياً بمنظار الجاهلية قد يكون سلبياً بمنظار الإسلاميين. فوأد البنات كان قيمة إيجابية بنظر الجاهليين، يتخلصون فيه من مصدرٍ سلبي قد يجلب عليهم العار، فيعلّقون عواطفهم ويجهدون عقولهم وجوارحهم في التخلص من بناتهم. ثم جاء الإسلام فعكس الآية وقلب المعايير وحارب تلك القيمة واعتبرها سلبية يجب التخلص منها وتم له ذلك.
كذلك فتغير المدلول للمصطلحات( ) حاصل تغيره بتغير البيئة الطبيعية والاجتماعية. فما كان سلبياً عند الحجازيين، قد يكون إيجابياً عند التميميين( ) .
وما كان سلبياً في العصور التي تقصدها الرسالة قد يكون إيجابياً في عصرنا الحديث، أو بالعكس. وقد تحافظ القيمة على سلبيتها أو إيجابيتها بالرغم من تغير العصر أو البيئة. فالعصبية القبلية دليل القول الأول، كانت قيمة إيجابية في نظر الجاهليين، ثم أصبحت سلبية بمنظار الإسلاميين وهي دليلنا على القول الثاني أيضاً. فقد استمرت سلبيتها حتى العصر الحديث ولذا ونحن ندرسها بمنظار عصرنا نراها قيمة سلبية.
ويبقى حديث السلبية والإيجابية – هنا – بعيداً عن الثبت الإحصائي القائم على التقسيم، بقدر ما هو نظرة تحليلية لا تغفل منظار العصر، ولا تعني إهمالاً للعصور التي تقصدها الدراسة لبيان أثرها في مناحي الحياة قديمها وحديثها.
ويبقى أن أشير إلى المراحل الشعرية التي أبدأ بها منذ الجاهلية. فقد مرّ الشعر الجاهلي بمرحلة حضانة ثم استوى عوده، واستقام شأنه، وعلا نبره، بعد أن كان الكلام كله نثراً( ) ، فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم الأخلاق، وطيب الأعراق وذكر الأيام الصالحة، والأوطان النازحة لا لتهز نفسها إلى الكرم كما ادعى بعض نقاد الأدب القدامى( ) ، فهذا تحليل سطحي، ولكن لحاجة في المرء يشعر بها، ويؤكد عليها علم النفس الأدبي( ) .
إن الشاعر يقول الشعر لعدة أسباب، أهمها:
- أنه يشغل الآخرين بنتاجه.
- أنه يخلد نفسه بهذا النتاج.
- وأنه يحب من يحسن إليه، والمديح الذي يتلقاه الشاعر نوع من الإحسان.
- وأنه يعبر عن خلجات وانفعالات تلجلج في صدره، ولا تجد طريقاً تخرج منه سوى هذه التفاعيل.
- وأنه وجد في نفسه ميلاً فطرياً إلى هذا النوع من الكلام، فنمّاه بالموهبة وقوّاه بالتجربة، وربطه بالناس، فلم يعد يستطع بعداً عنهم.
ثم إن أولية الشعر العربي مجهولة، ولا نعتقد أنه حديث الميلاد، صغير السن، سبق الإسلام بخمسين ومائة عام أو بمئتي عام على غاية الاستظهار كما ادعى الجاحظ( ) .
لذا كان الحكم منصباً على الشعر الناضح مباشرة، وهذا هو الأصل الذي يجب أن يكون. وهو في نضجه يعطي صورة تامة عن قوة الكلام العربي الذي يعبر عن قوة الإدراك، وعن قوة في الإرادة. فالشعر الناضج أعطى صورة تامة لحياة الناس، وفكر الناس وعيش الناس ونمط معاشهم، ودخل كل معنى وكل شعب في حياتهم.
وإذا كان الشعر الجاهلي ظلاً للمجتمع الجاهلي، فلا مندوحة من التسليم بالسلبي والإيجابي الذي يحتويه هذا الشعر، بعيداً عن التقسم النوعي.
وكذلك فالشعر الإسلامي ظل لمجتمعه مع وجود القرآن والحديث، فلا مندوحه أيضاً من البحث بالسلبي والإيجابي الذي يحتويه.
وندع هذا، لندخل في الحديث عن المناحي المختلفة التي خاض فيها الشعر قريباً من التحليل والاستقراء التاريخي.
الباب الأول :
العصــــر الجاهلــــي
الفصل الأول
المفاهيم الســـلبـية:
1-المناحي الاجتماعية.
* التفاخر بالأنساب
* العصبية القبلية
* شعر التحريض
2-المناحي الفكرية.
* الطيرة والأوهام والخرافات
* الغيلان والسعلاة، ومزاعم أخرى
3-المناحي الاقتصادية.
4-المناحي التربوية.
*توجيه السلوك الاجتماعي والأخلاقي بشكل خاطئ
المنَاحي الاجتماعيَّة
- التفاخر بالأنساب.
الأنساب، واحدة النسب( ) ويعني القرابة. وهو الرابط الذي يربط شمل القبيلة ويجمع شتاتها. وذلك لأن أفراد القبيلة كلهم يشتركون بنسب واحد. والنسب عندهم هو القومية ورمز المجتمع السياسي في البادية( ) .
وقد اهتم العرب كثيراً بالأنساب واعتبروها علماً واسعاً من العلوم التي تشغل تفكيرهم كثيراً، والتي تستأهل منهم المصنفات الضخمة( ) وهذا يدل دلالة واضحة على المكانة الخطيرة التي لعبتها الأنساب في حياة العرب.
فقد كانت هذه الأنساب توفّر الحماية والوقاية للإنسان، قبل أن تتولد الحكومات الكبيرة التي جاءت فيما بعد، فرعت الأمن وبسطت سلطانها وخففت من غلواء النسب والانتساب( ) .
فهذا النسب، على هذه الشاكلة ظاهرة إيجابية، ومفهوم جيد في الحياة القبلية العربية. لأنه يربط شمل القبيلة،ويجمع شتاتها ويحميها من كل معتد أو طامع. لكنه حين يدفع إلى التفاخر والخيلاء، والزهو والغطرسة، يصبح ظاهرةً سلبيةً منبوذةً. يجب كشف ضررها، وبيان المناحي السلبية فيها.
وهي إذ تصبح كذلك، تنبذ ويؤخذ بالحسب بدلاً منها. وهذا سر نبذ الإسلام للتفاخر بالأنساب، واحترامه للحسب، على أنه الفعل الحسن كما في الحديث النبوي: "حسب الرجل خلقه( ) " وحسب المرء دينه مروءة عقله، وحسبه( ) عقله أيضاً.
وبهذا يكون الحسب أحياناً معززاً للإيجابي من النسب، وملتزماً معه بفائدة المجتمع وجزءاً من الخير العام الذي ينمّي القيم والمفاهيم الإيجابية.
وقد أكد بعض الشعراء قيمة هذا التلازم بين النسب والحسب، ليأتي منهما الخير العميم، وإلا فالنسب الكريم دون حسب يحميه يصبح لئيماً ذميماً كما في قول المتلمّس( ) :
ومن كان ذا نسب كريم، ولم يكن
له حسب، كان اللئيم المذمما( )
ويجنح هذا المفهوم إلى السلبية المغرقة حين يدفع كثيراً من القائلين به إلى التطرف بالتفاخر، وهو التعاظم، فيصبح هذا التفاخر من أهم مظاهر الحياة الاجتماعية سلبية( ) .
وينشغل العرب بهذا الأمر، فيتفاخرون بالآباء والأجداد، وبالسيادة والشرف، وبالكثرة، وبالحسب( ) . ويجرّهم هذا التفاخر إلى الشطط، والتخلف الاجتماعي المؤلم، فيحصل النزاع بين قبيلتين أو أكثر.
وقد علا هذا النبر السلبي ذات مرة في المدينة وجر إلى نزاع بين قبيلتين من الأنصار، بني حارثة، وبني الحارث، فتفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان ومثل فلان؟ يشيرون إلى القبر وتقول: الأخرى مثل ذلك، فأنزل الله( ) : "ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر( ) ".
وقد اشتهر في هذا المنحى قول للشاعر المخضرم عمرو بن معد يكرب الزبيدي، يقول فيه( ) :
ليس الجمالُ بمئزرٍ
فاعلم وإن رُدّيت بُرْدَا
إن الجمالَ معادنٌ
ومناقبٌ أورثنَ حَمْدَا
فعمرو – الذي أسلم فيما بعد – لا يكتفي بالمناقب، وهي الأعمال والخصال الحميدة، بل يصرّ على المعادن، وهي الطبائع الشريفة التي يرثها الرجل عن آبائه.
وإذا كانت المناقب وجهة إيجابية، فإن التفاخر بالمعادن فقط وجهة سلبية، إذا لم يرافقها من المناقب ما يثبت ذلك فالأصل تتبعه الفروع وكي تكون الفروع مثل الأصل، يجب أن تَحْمِلَ مناقبَ الأصلِ كذلك.
وقد بلغ من إيمانهم بالنسب أن اعتقدوا أن النسب الوضيع – أو اللئيم كما سموه – لا يزكيه عمل مهما يكن حميداً!.. ومن هذا ندرك أنهم قبل الإسلام كانوا يؤمنون بأرستقراطية مسرفة تساوي في إسرافها الأرستقراطية الإنجليزية في العصر الفكتوري، حين كان الإنجليز يؤمنون أن بعض الدماء زكية أو (زرقاء) بطبيعة وراثتها، وأن من ولد من العامة لا يصير أبداً إلى أن يكون من الأشراف، حتى قالوا: (أن الملك يستطيع أن يمنح الألقاب ولكنه لا يستطيع أن يجعل من الشخص العادي جنتلماناً( ) ؟).
وقد جعلهم هذا المفهوم متغطرسين أحياناً، بحيث أن كثيراً منهم كان يعقد الأولويّة لنفسه في كل شيء، لأنه أفضل منهم، بل ربما غالى فجعل نفسه أفضل من كل الأموات أيضاً، ولو عُدّت قبور هؤلاء الموتى واحداً بعد واحد، كما جاء على لسان الشاعر الجاهلي عصام بن عبيد الزمّاني( ) في رسالة شعرية أرسلها إلى أحد أصدقائه( ) :
أبلغ أبا مَسْمَعٍ عنّي مغلغلةً
وفي العتاب حياةٌ بين أقوام
أدخلتَ قبلي قوماً لم يكنْ لهم
في الحق أن يدخلوا الأبواب قدّامي
لو عُدَّ قبرٌ وقبرٌ كُنْتُ أكرَمهم
ميتاً وأبعدَهم من منزلِ الذَّامِ
ومن هذا ندرك أن أياَ من أبعد الأشياء عن الصحة أن ننسب إلى الجاهليين أي إيمان بالديمقراطية الصحيحة. ويجب علينا في هذا المجال، ألاّ نخلط بين الديمقراطية الصحيحة – وهي التي تنبع من إيمان عميق بأن الناس متساوون في قيمتهم الإنسانية وأن لكل منهم حقاً متساوياً في الحياة الكريمة – وبين التقارب في الحالة الاقتصادية الذي فرضته على معظم الجاهليين طبيعتهم الصحراوية الشحيحة القاسي( ) .
وقد تجلت المناحي السلبية لهذا المفهوم الجاهلي كذلك في فكرة مراعاة التكافؤ في الزواج، وهذا المفهوم هو نتيجة من نتائج فكرة النسب السلبية. فالأشراف لا يتزوجون إلا من طبقة مكافئة لهم، والسواد لا يتجاسرون على خطبة ابنة سيد قبيلة، أو أحد الوجهاء ويعيّر السيد الشريف، إن تزوّجَ بنتاً من سَوَاد الناس ولاسيما، إذا كانت ابنة صائغ أو نجّار أو ابنة رجل يشتغل بحرفة من الحرف اليدوية، لأنها من حرف العبيد!... وقد عيّر الشاعرُ الجاهلي عبدُ عيسى بن خفاف البرحميُّ( ) النعمانَ بن المنذر بأمه، لأنها كانت ابنة يهودي صائغ في قوله( ) :
لعنَ اللهُ ثم ثنّى بلَعْنٍ
ابنَ ذا الصائغِ الظلومَ الجهُولا
يجمعُ الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأ العدوَّ فتيلا( )
ولم يكن من المستساغ عُرْفاً تزويج البنت الأصيلة الحرّة من ابن عبد أو من حفيد عبد( ) .
هذا المعتقد أوجد لديهم سلاحاً فعالاً في الهجاء، فصار الواحد من الشعراء إذا غضب من أقرب الناس هجاه، ولو كان من أهله وذويه. وإذا بحث عن مطعن أو مهمز، تذكر أنه من اللؤماء، أو ربما هجا قبيلته بأكملها فرآها من اللؤماء، وأن قومه لم يؤتوا في لؤمهم من قبل أمهاتهم، وإنما أتوا من قبل آبائهم، وأن المرأة الكريمة منهم تتزوج الرجل المسروق النّسب، كما في هجاء عميرة بن جُعل قومهَ بني تغلب في نزعة طيش وساعة سفه، إذ يقول( ) :
فما بهم ألاّ يكونوا طَرُوقَةً
هجانا، ولكن عفّرتها فحولُهَا
ترى الحاصنَ الغرّاء منهم لشارفٍ
أخي سَلّةٍ قد كان مِنْهُ سلْيلُهَا
وقد نجم عن هذا الادعاء – في ضرورة الزواج المتكافئ على أساس النسب في انحرافه السلبي – إلغاء فكرة الزواج على أساس الحب المتبادل إن لم يكن ثمة تكافؤ بين الحبيبين على أساس من تلك الفكرة، وهذا ما يفسر كثيراً من قصص الحب العربية التي لم يتزوج أصحابها كما حدث لعنترة بن شداد، أو لغيره من أبطال القصص الغرامية الكثيرة.
كذلك يستنتج من الانحراف الذي حدث في هذا المفهوم سبب انتشار ظاهرة الفخر التي خدّرت كثيراً من عقول القبائل العربية، قديماً وحديثاً، حتى غدا هذا الفخر أيضاً عاملاً من عوامل التخلف يقاوم سنن التطور، فلطالما دندن العرب بمثل قول لبيد بن ربيعة العامري( ) حين يتحدث عن أهله ويراهم:
ومن معشر، سنّت، لهم، آباؤهم
ولكلّ قَوْمٍ سنّة، وإمامُها( )
فهذا المفهوم المتوارث ذو نظرة قاصرة تولّد في المرء اتكالية وضعفاً، كما أنّه لا يملك المعاصرة ولا الأصالة في مجتمع متطور متنقّل.
ولكي نظهر جوانب السلبية أكثر في هذا المفهوم ومن هذه الزاوية، لابد من أخذ مثال عنه بعد ظهور الإسلام. فقد ظهر دوره في مناهضة التطور الجديد من خلال الجمود العقلي والتصلب الفكري فيه مع محاربة الإسلام له. فجميل بن معمر العذري( ) ، أحد أولئك الشعراء الإسلاميين الذين يتناولون هذا المعنى بعيداً عن الروح الإسلامية الجديدة، في قوله( ) :
أبوكَ حُبَاب سارق الضيف بُرْدَه
وجدّي يا حجّاج فارسُ شَمّرا( )
بَنو الصّالحين الصّالحون ومن يكن
لآباء صدقٍ يلقهم حَيْثُ سَيّرا
فهي القصيدة الجاهلية نفسها وإن كان الشاعر في شطره الأول قد استبدل بالشرف والمجد كلمة إسلامية كما في البيت الثاني (الصلاح).
ولعل هذا المفهوم السلبي مازال حتى اليوم من أكبر العوائق التي تحول دون اجتماع رأسين على وسادة واحدة. وما زال ينخر كثيراً في جسم المجتمع العربي المعاصر. فجمع من الناس يحتقر جمعاً آخر، وفرد منهم قد يحتقر فرداً آخر على الرغم من الحسب العظيم الظاهر في حسن فعالهم، فيزدرونهم لأنهم – بزعمهم – لا يملكون النسب الرفيع!...
ومثل هذا الأمر نعاني منه كثيراً في الجزيرة الفراتية من البلاد الشامية حتى أيامنا هذه.
- العصبية القبلية:
العصبية هي: "النصرة على ذوي القربى، وأهل الأرحام، أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة( ) .
والعصبية القبلية على هيئتها الجاهلية هي أساس النظام القبلي،وهي تعم العرب كلهم حضراً، وبدوا، وكما ظهر معنا في بداية مناقشة مفهوم "النسب" فإن العصبية القبلية ذات حدّين، فهي ظاهرة إيجابية في الحياة الاجتماعية العربية حين يكون المقصود بها نصرة دوي القربى حقاً؛ ذلك لأن الظروف التاريخية، والبيئة العربية الصحراوية، وما للمجتمع العربي من إطار قبلي، كل هذه الأمور جعلت العصبية القبلية من هذا الجانب ظاهرة نافعة وضرورية للمجتمع.
ولكن هذا المفهوم يصبح له جانب آخر مقيت ومؤذٍ حين يتّخذ منه الشعراء مواقف موحّدة، في أوقات، أو حالات تقتضي من الشعراء أصحاب العقل والاتزان، ودقّة الشعور ضرورة التغيير على مبدأ لكل حادث حديث ولكل عصر مواقف جديدة تقابل المفاهيم الجديدة، والمفاهيم القديمة المتطورة.
ولكن التغيير لم يكن يحدث في كثير من الأمور وعلى العكس ظل مفهوماً أنه" ليس من العصبية والأخوّة القبلية أن تسأل أخاك عمّا وقع له. عليك تلبية ندائه، وتقديم العون له، معتدياً كان أم معتدى عليه( ) " وقد افتخر الشعراء بتلبية النداء، وإبعاد السؤال، كما في قول الشاعر القريط بن أنيف( ) :
قومٌ إذا الشّر أبدى ناجذيه لهم
طاروا إليه زرافاتٍ ووحدَانا
لا يسألونَ أخاهم حينَ يندُبهم
في النائباتِ على ما قالَ بُرْهَانَا
إن هذا التمسك منبعه خارجي، فكأن الظروف الطبيعية المحيطة بكل قبيلة تدفعها من جميع الجهات فتنكمش على نفسها، ولو أنها أهملت فرداً من أفرادها تعرض لشر عصبة أو قبيلة، ونجا، لعجل على تجنّب قبيلته والابتعاد عنها ونبذها. وتكرار هذا إنما يعني فرط عقد القبيلة التي كانت تمثل الوحدة الأساسية للمجتمع العربي في الجاهلية، وإذا حدث هذا فليس للقبيلة إلا الهجاء المُسرِّ المتمثِّل بالتمني خلاصاً من مورثاتها وانتساباً إلى قبيلة أخرى تمنع أفرادها أن يُستباحوا، وتكون الفضيحة حتى في أحسن الظروف،كما قال قريط( ) بن أنيف نفسه:
لو كنتُ من مازِنَ لم تستبح إبلي
بنو اللقيطة من ذُهْلِ بن شيبانا
ويصبح من المحتم على الفرد أن يبقى ضمن إطار قبيلته لأسباب معنوية ومادية، فالجانب المعنوي يعطيه صفة قتالية شجاعة، فيصبح لاحقاً بها، حتى إذا نصرف عنها قليلاً، اتهم بالخوف، فاضطر إلى الدفاع عن نفسه كما فعل طرفة بن العبد:
ولستُ بحلاّل التلاع، مخافةً
ولكن متى يسترْفِدِ القومُ أرْفد( )
ويعود مردود الجانب المادي على القبيلة فتبدو متمسكة قوية تهابها القبائل الأخرى.
وقد كان يُخشى من حركة الصعاليك لسبب آخر غير سيفها، والخشية في كونها قد تصبح بديلاً حياً عن الوضع القبلي، الذي لم تكن الأمة على جانب من التطور بحيث تتخلى عنه، مع أن واقع الحال يثبت استنتاجاً مفاده أن الخيوط الرابطة تبين أفراد القبيلة أقواها خيط المصلحة الاجتماعية والاقتصادية في صحراء لا شرعة فيها ولا قانون، ثم أصبحت قالباً دموياً فيما بعد. مع ذلك فلو أتيح لحركة الصعاليك أن تجد قبولاً شعبياً أفقياً وعمودياً، لحلّت محل العصبية القبلية!...
وهذا الاندماج الكامل لشخص الشاعر في هيكل القبيلة أمر غير مقبول، أدّى إلى اختلال في فكر الشعراء، مما جعل العاقل النابه منهم، يتبع جاهل القوم، تحت ضغط الأعراف والتقاليد، وقد يملك رأياً ينقذ به القبيلة لو حملها عليه، لكنه يسير في إطار التبعيّة حيث الغيّ والرشد مرتبطان بالعشيرة؛ قال دريد بن الصمة( ) :
أمرتُهم أمري بمنعرج اللّوى
فلم يستبينوا الرّشدَ إلاَ ضُحى الغدِ
فلمّا عصوني كنتُ منهم وقد أرى
غوايتهم وأنني غيرُ مُهْتَدِ
وما أنا إلا من غزيّة إِنْ غَوت
غويتُ وإِنْ ترشد غزيّة أَرْشدِ
ونستطيع أن نرى خلاصة للعصبية في أنها عصبيتان، عصبية مضرّة بالقبيلة، وعصبية مفيدة للقبائل مجتمعة فهي "من الضرورات اللازمة بالنسبة إلى الحياة فهي الجاهلية، لأنها الحائل الذي يحول بين الفرد، وبين الاعتداء عليه، والرادع الذي يمنع الصعاليك والحلفاء، والمستهترين بالسنن من التطاول على حقوق الناس، إذ لا حكومة قوية رادعة ولا هيئة حاكمة في استطاعتها الهيمنة على البوادي، وعلى الأعراب المتنقلين.
بل هناك قبائل متناحرة، وإمارات متناصرة، إذا ارتكب إنسان جريمة في أرضها، وفرّ إلى أرضٍ أخرى نجا بنفسه، وأمّن على حياته هناك ولكنه كان يخشى من شيء واحد،لم يكن لأحدٍ فيه عليه سلطان هو العصبية وسنّة الأخذ بالثأر حيث يتعقبه أهل المغدور، فلا يتركون الجاني يهنأ بالحياة، ولو بعد مضي عشرات السنين حتى يقتل، أو يقتل أقرب الناس إليه. وبذلك صارت العصبية ضرورة من ضرورات الحياة بالنسبة لسكان جزيرة العرب لحمايتهم وصيانتهم من عبث العابثين( ) ".
ولكنها إذا جعلت الحق باطلاً، والباطل حقاً، تصبح غير مقبولة أبداً وهي سمة منبوذة،والحكم الفصل بين الوضع الأول والوضع الثاني. هو موقف الإسلام منها، فقد كثرت الآثار في ذمها، واعتبرتها شيئاً خطيراً، وعاملاً دائماً في زلزلة الجماعة.
ورد عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عميّة يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهليّة( ) ...")
كما اعتبرها الإسلام أخطر ما يمزق جسم المجتمع، وبيّن أن القتال تحت رايتها جاهلية عمياء. وأحاديث هذا الموضوع كثيرة، ولكن بعضها يحمل إشارة حمراء تفضح خطر العصبية( ) .
وتنطلق العصبية من عقال السلبية إذ تصبح مجلس أمن تثار فيه القضايا المصيرية للقبيلة، وتبحث فيه أفضل الحلول المناسبة، وتصبح استشارة أصحاب البيان والرأي في القبيلة أو في غيرها مثار فخر، إذا غاب عن المرء وجه الرأي الصحيح، يقول سعية بن الغريض( ) :
إذا ما يَهْتَدي حلمي كَفَاني
وأسأَلُ ذا البيانِ إذا عَييتُ
فهو لا يستتكف عن استشارة غيره إذا غاب عنه الوجه الصحيح، كما أنه يفخر بإعانة قومه وبنصرهم.
وهو لا يسير إلى نهاية الأمر تعصباً، ويعذرهم على بعض تصرفاتهم، فلا يلومهم في وقفتهم بوجه الدهر وأحداثه، ويرى المجد والعزة في ثوب المغامرة. ويصل إلى الإيجابية المطلوبة منه، مما يدل على تطور في وعيه جعله يدرك قضايا السوء والخير، فيفخر لمفارقة السوء، ويخالف هوى النفس إذا بان له الضرر، يقول( ) :
ولا أَلْحى على الحَدَثان قومي
على الحدثان ما تُبْنى البيوتُ( )
أُياسِر معشري في كلِّ أمر
بأَيْسَر ما رأيتُ وما أريتُ
وداري في محلِّهمُ ونصري
إذا نزلَ الألدُّ المستميتُ( )
وأجتنبُ المَقاذعَ حيثُ كانت
وأتركُ ما هويْتُ لما خَشِيتُ( )
وأحياناً لا يكاد المرء يتبين وجهاً للمسألة،وهنا يأتي دور المحاكمة الفكرية، فإذا حدث أن قتلت القبيلة أحد أفرادها، فما هو موقف الشاعر في القبيلة ذاتها، أو موقف أهل القتيل، وربما كان الشاعر فيهم؟.
لم يكن في المسألة بت، فبعضهم يفجع بقتل أخيه، ولا ينتقم له، فإذا انتقم له عاد ضرر ذلك عليه، لأن الرجل بعشيرته، وإذا صفح وعفا فهو خير له، فالانتقام من عشيرته يوهن عظمه ويضعف قومه. فعوضاً عن متابعة طلب الثأر الذي يستدعي بدوره ثأراً آخر تنتهي القضية بالوصول إلى حل مقبول (ثمن الدم) فيتقبل المنتقم ذلك على كره منه لأن شرفه قد مس، ولكن المداخلات التي أملاها الحس السليم، ومراعاة المصالح تتغلب على وساوسه فيرضخ للأمر الواقع بعد مساومات( ) . "وفي هذا يقول الحارث بن وَعْلة الجرمي( ) وقد قتل قومه أخاه( ) :
قَوْمي هُمً قَتَلو أُمَيْمَ أخي
فإذا رَمَيْتُ يصيبني سَهْمِي
فَلَئِنْ عَفَوْتُ لأَعْفون جَللاً
وَلَئِنْ سَطَوْتُ لأوهِنَنْ عَظْمِي
وربما تبادر إلى الذّهن أنّ الخوف كان حائِلاً دون الانتقام، ولا يستبعد ذلك، ورغم أنه حوّل الكلام من الإخبار إلى الخطاب فإنه قد أجرى محاكمة عقلية في ذهنه تنم عن إدراك للبيئة وللعادات والتقاليد التي حوله.
لكن جلاء الأمر في إطار من الإيجابية يظهر في حادثة قتل أقرب كما في قول أعرابي قتل أخوه ابناً له( ) :
أقولُ للنَّفس تَأْسَاءً وتَعْزِيَةً
إحدى يديّ أصابتني ولم تُرِدِ( )
كلاهما خَلفٌ من فَقْد صاحِبِه
هذا أخي حين أَدْعُوه وذا وَلَدِي
يثبت الشاعر في إيجابيّة فيها تعقّل واتّزان أنكل واحد من الأخ الواتر والابن المفقود يصلح لأن يكون عوضاً من فقدان الآخر، فيطفئ، لهيب القلب على الولد المقتول بهذا الفكر المقلوب بالشعر، مدركاً أن الاقتصاص من أخيه يضعف مركزه في القبيلة فيكتفي بمصيبة واحدة.
ومع كثرة النصوص الجاهلية التي تصور التعصب القبلي بأنواعه المختلفة والتي ترفد نهر العصبية الكبير، فإن هناك مواقف أخرى لشعراء من قبائلهم لا تأتي على شاكلة التعصب، وإِنْ هي إلاّ شكل من أشكال الأنَفَة والعزّة. وهذه من السمات الإيجابية الموفّقة التي جاءت في الشعر الجاهلي.
فقتلُ خادمِ، أحد أثرياء قبيلة (خزيمة) العربية، يثير نخوة سيده فينتقم من القتلة مع أنهم أولاد عمه، ويفارق أهله من أجلهم.
أنفة فيها بسط الحماية على الخدم والموالي. ولو أدّى الأمر إلى فراق القبيلة التي تصبح غادرة باغية كما في قول طرفة الخزيمي( ) :
أَيَا راكباً إِمَّا عَرَضْتَ فبلِّغَنْ
بَني فَقْعسٍ قولَ امرئ نَاخِل الصّدر( )
فوالله ما فَارَقْتُكم عن كَشَاحةٍ
ولا طيب نفسٍ عنكم آخر الدَّهْرِ( )
ولكنّني كنْتُ امراً من قَبِيْلَةٍ
بَغَتْ وَأَتتني بالمظَالِم والفَخرِ
فإنّي لشرّ الناس إن لم أتبهُمْ
على آلة حَدْبَاء نَائِبَة الظّهر( )
ولكن دافع الأنفة مصلحة شخصية دفعته ليأخذ بثأره. ويبقى أن نلاحظ ضمنياً موافقة الطبقة الغنية المتحكمة برقاب العبيد على تصرف طرفة وأمثاله. ويصبح للمسألة طرف آخر حين نتذكر أن دفاع الأغنياء والمالكين عن عبيدهم يصرّف الطاقة الثورية لدى هؤلاء العبيد، وهذا نوع من علم النفس الدعائي يعرفه البدوي بفطرته.
وهكذا فالعصبية القبلية في الجاهلية ظاهرة فيها أخذ وعطاء بين السلبية والإيجابية، وربما اتصل السالب فيها بالموجب أحياناً فتكون الإضاءة المقبولة.وأكثر السلبي نجده عند شعراء القبائل التي كانت مشغولة بالحروب دائماً.
وقد كانت قانوناً تتوارثه أجيال الجاهليين. وعلى العموم فقد كان هذا القانون الصحراوي نفسه موضع التنفيذ أيضاً في مدن الحجاز: الطائف، ومكة، والمدينة( ) ".
كما تلخص قوانين العرف المشرّبة الإيجابية، بأن الغرض منها جعل الحياة ممكنة في الصحراء، ولذلك بالحدّ من اندفاعات كل فرد من الأفراد، فلكل ذنب قصاص، ويكفي وجود القوة لتطبيق هذا القصاص، ومن هنا تظهر فائدة الثأر المشؤوم بحد ذاته بما يثيره من أحقاد( ) .
شعر التحريض:
التحريض على القتال: هو الحث والإحماء عليه، وهو الحض فإذا كان القتال في سبيل أرض أو أخلاق أو اقتصاد، أو لرد عدوان، فهو الإيجابي المقبول، و إذا كان لغير ذلك فهو السلبي المذموم.. وسوف نرى أن التحريض أشكال متنوعة مختلفة.
كان الشعر – في بعضه – يستنفر الملوك، ويحرضهم على القتال. فقد يستنفر ملكاً على إحدى القبائل قتالاً وتحريضاً لعداوة موغلة في صدر شاعر، أو يستنفر قبيلة ويحرضها على أخرى، أو فرداً يحرضه على آخر فيقتله. ثم تبدأ سلسلة الأخذ بالثأر ويكون سبب هذا القتال والعداوة والبغضاء شاعراً محرضاً متخذاً المواقف السلبية المؤلمة التي تنخر بجسم الأمة.
فمن باب تحريض الملك على القبائل ما فعله أوس بن حجر( ) . فقد أغرى النعمان بن المنذر ببني حنيفة لأن شعر بن عمرو السحيمي قتل المنذر، وهو حينئذ مع الحارث بن أبي شمر الغساني، فقال:
نُبّئْتُ أنَّ بني حنيفة أدْخَلًوا
أَبْيَاتهم تامورَ قَلْبِ المُنْذِرِ
فغزاهم النعمان، وقتل فيهم وسبى، وأحرق نخلهم. فشعر بن عمرو السحيمي أحد أفراد بني حنيفة، يستشف من روح الموقف أن عداءً مستحكماً اشتد بين بني تميم وبني حنيفة، كما يظهر أن قبيلة حنيفة حظيت بمكانة مرموقة عند النعمان. وهذا يوفر لها المراعي الخصبة لمواشيها التي تشكل عنصراً رئيسياً في حياتها الاقتصادية، لذا نرى التحريض ينصب على التذكير بمقتل المنذر،فيدفع ابنه النعمان بثورة غاضبة، فيقتل منهم ويسبي من نسائهم، ويحرق نخيلهم، ولاشك أن إحراق النخيل انتقام اقتصادي وإجراء مهم ضد بني حنيفة بسبب اشتراكهم مع الحارث بن أبي شمر الغساني في مقتل المنذر.
وقد يحرض الشعر ملكاً على فرد، فيؤدّي إلى قتال مرير يذهب بقوى القبائل الاجتماعية والبشرية والاقتصادية كما كان يحدث في أيام العرب، ولاسيما في يوم (أواره الثاني).
فقد ترك عمرو( ) بن المنذر اللخمي ابنا له اسمه أسعد عند زرارة بن عدس التميمي. فلما ترعرع مرّت به ناقة سمينة فعبث بها، فرمى ضرعها، فشد عليه ربها سُوَيْدٌ أحد بني عبد الله ابن دارم التميمي فقتله وهرب. فلحق بمكة فحالف قريشاً. وكان عمرو بن المنذر غزا قبل ذلك ومعه زرارة فأخفق، فلما كان حيال جبلي علي قال له زرارة:
أي ملك إذا غزا لم يرجع ولم يصب، فحل على طيء فإنك بحيالها فمال إليهم فأسر وقتل وغنم، فكانت في صدور طيء على زرارة، فلما قتل سويد أسعد، وزرارة يومئذ عند عمرو، قال لـه عمرو بن ملقط الطائي( ) يحرض عمراً على زرارة:
من مبلغ عمراً بأن المــرء لم يُخلَق صُبَارَهْ
ها إن عجزة أمّهِ
بالسّفحِ أَسْفَل من أُوَارَهْ
فاقتل زرارةَ لا أرى
في الْقَوْمِ أوفى من زُرَارَهْ
فقال عمرو:
يا زرارة ما تقول؟ قال: كذبت، قد علمت عداوتهم فيك. قال: صدقت. فلما جن الليل هرب زرارة إلى قومه فمالت الكفة ببني تميم الذين حرضوا النعمان على بني حنيفة،وقد ابتدأ كبيرهم عمرو فحث الملك عمرو بن المنذر على غزو طيء، فكانت تتحيز الفرصة لتنتقم لنفسها.
ولاشك أن الطائيين كانوا قادرين على محاربة التميميين ولكن حماية الملك لهم كانت تمنعهم من تحقيق هدفهم، فكان لابد من وضع هذا الإسفين بينه وبينهم. وهذا الشعر يحل محل الحرب الباردة في في إعلام العصر الحديث.
وهناك شعر شبيه بالتحريض وما هو بالتحريض!!.. لأن قائله معتدى عليه ومهدد، فيدافع عن نفسه وينتصر ويشتفي من الظالم لهُويّ صرحه.
خرج الحارث بن أبي شمر الغساني، ملك غسان بالشم فمرّ بأفاريق( ) من تغلب فلم يستقبلوه، وركب كلثوم بن عمرو التغلبي( ) ، فلقيه فقال له: ما منع قومك أن يتلقوني؟ فقال: لم يعلموا بمرورك، فقال: لئن رجعت لأغزونهم غزوة تتركهم أيقاظاً لقدومي. وهدد كثيراً. ولما عاد غزا بني تغلب، فاقتتلوا واشتد القتال بينهم ثم انهزم الحارث وبنو غسان، وقتل أخو الحارث في عدد كثير، فقال عمرو بن كلثوم( ) :
هلاّ عطفت على أخيك إذا دعا
بالثكل ويلَ أبيك يا ابن أبي شمرِ
فذق الذي جشَّمْتَ نفسَكَ واعترف
فيها أخاك وعامر بن أبي حُجْرِ( )
أنه التشفي من الظالم ورد الاعتداء وإيلامه بذكر من قتل من أصحابه، وهو يستحق ذلك لأنه جلب الشر على قومه.
والشعر الذي كان ينمي الفتن بين القبائل نوع من أنواع شعر التحريض وهو ظاهرة سلبية نراها في الحياة الاجتماعية الجاهلية. فمثل هذا الشعر كان عاملاً رئيساً في المحافظة على نار الحرب مشتعلة يذكي من جذوتها ويحميها. ويعمق الإحساس بالحقد والكراهية.
ولعل كثرة هذا الشعر هي التي عملت على كثرة أيام العرب، وشعر تلك الأيام حافل بالمعاني والمواقف السلبية التي نقصدها، فلكل يوم من أيامهم قصة وراءها شعر التحريض الذي يمثل فخراً وعزاً للمنتصرين، وصغاراً وذلاً للمنهزمين، ويدور على الألسنة فيكون حطباً جذلاً تحت جفان الحروب الداخلية، فيفتت عضد الأمة ويضعفها.
إنه ليس من غايتنا الوقوف عند أيام العرب أو عند شعر أيامهم كله. فهذا أمر يطول ذكره، وفي كثر من الكتب ما يغني عنه. ولكننا نأخذ عينه على ما نثبته في هذه الظاهرة ونترك شأن أيام العرب، لمن أراد أن يعود إليها( ) .
تطاحن العرب في يوم يقال له: "يوم النسّار". ومرت سنة كاملة من الحرب الباردة ثم التقى المتقاتلون في يوم النسّار مرة أخرى بفعل تلك الحرب في موضع يقال له: "الحفار"، فقتل خلق كثير وكشف القتال عن صبر تميم وعامر، لكن هذا المصير لم يكن حائلاً دون الهزيمة، فأكثر بشر بن أبي خازم الأسدي على بني تميم فقيل له: مالك ولتميم وهم أقرب الناس منك أرحاماً؟، فقال: إذا فرغت منهم فرغت من الناس ولم يبق أحد. وتشفى بقتله، فقال:
غضبَتْ تميم أن تُقَتّل عامَِرٌ
يوم النِّسار فأعقبوا بالصَّيْلَمِ( )
وتسير القصيدة في تعميق الشقاق والحث على متابعة القتال، وكأنه يعطي لبني تميم مبررات ومسوغات كثيرة لتعد جموعاً جديدة للقتال.
وفيها يخاطب تميماً وعامرا ويعيرهما بما لحق بهما من ذلك وفشل، ثم يشير إلى فرار رأس تميم في يوم "النِّسار( ) " حاجب بن زرارة، وإلى سقوط راية بني تميم، وعلو راية بني أسد عليها، ويفتخر بقومه، إذ يقول:
سائلِ تميماً في الحروب وعامراً
وهل المجرّب مثلُ من لم يَعْلَمِ
غضبت تميم أن تُقتَّلَ عامرٌ
يوم النِّسار فأُعقِبُوا بالصَّيْلمِ
ورأوا عقابهم( ) المدلِّة( ) أصبحت
نُبِذَتْ بأفضح( َ) ذي مخالبَ جَهْضَمِ( )
وتناول بني نمير وكلابا ولم ينس كعبها، فأشانهم جميعا في قوله:
وبني نُمَيْرٍ قد لقينا منهم
خيلاً تَضِبُّ لثاتُها لِلْمغتَنَمِ
ولقد خبطنَ بني كلاب خبطة
الصقتَهُمْ بدعائمِ المتخيَّمِ
وصلَقْنَ كعباً قبل ذلك صلقةً
بقنا تعاورَهُ الاكفُّ مُقَوَّمِ
حتى سقيناهُمْ بكأس مُرَّةٍ
مكروهةٍ حُسُواتها كالْعَلْقَمِ( )
كان عليه أن يطيل الحديث عن نهاية المعتدي الأثيم، لا أن يصوّر ما قد يجلب لقومه البلاء، ويعزز عند أعدائه حب الانتقام والاعتداء فمثل هذا الشعر وسيلة إعلامية تشين قائله وتعترف بعدوانيته وتدينه في مجتمع جبل على المحافظة على المروءة والكرامة وحب الذات.
وأحياناً يأتي التحريض من فرد يمثل قبيلة، يحرض ملكاً على فرد يمثل قبيلة أخرى بدافع الحضوة والتنافس على المكانة المقربة من الملك. ولاشك أن وراء هذه المكانة دوافعَ كثيرةً في طليعتها الأحوال الاقتصادية، والمنافع المادية. كما في الحادثة التالية:
افترى لبيد بن ربيعة العامري على الربيع بن زياد( ) عند النعمان( ) فتأثر العبسيون بهذا الافتراء وتدنت مكانتهم، وضاقت أحوالهم. وسبب ذلك أن الربيع كان ينادم النعمان ويهوّن من شأن بني عامر عنده، فدفعت بنو عامر شاعرها الشاب لبيد بن ربيعة فهجاه في حضرة النعمان واصفاً إياه بالبرص( ) ، وتوجّه بكلامه إلى النعمان قائلاً( ) :
مَهْلاً أبيتً اللعنَ لا تأكُلْ معَهْ
إنَّه استه من بَرَصٍ مُلَمّعَهْ
إنَّه يُدْخِلُ فيها أصبعَهْ
يُدْخِلُها حتى يواري أَشْجَعَهْ
كأنه يطلب شيئاً أودعه
فسخط النعمان ونفر من الربيع وقال له: أكذلك أنت؟!.. فقال: كذب ابن الحمقى اللئيم، فقال النعمان( ) :
قَدْ قِيلَ ذلك إنْ حقاً وَإنْ كَذِبَاً
فما اعتذارُكَ من قَوْلٍ إذَاْ قِيْلاَ
ثم أمره بالانصراف إلى أهله، واشتعلت نار الفتنة بين القبيلتين بسبب هذا الشعر، و هو لا شك إيجابي بالنسبة لبني عامر، سلبي على بني عيس. لكنه سلبي بالنسبة للحركة الفكرية العربية عامة وللخط الذي نهجه في هذا البحث. وكفاه سلبية أنه أشعل نار الحرب بين العامريين والعبسيين مدة طويلة راح ضحيتها مئات من العرب، وكثير من المقدرات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد اعتمد على تشخيص الحسي فصور مشهداً منفّراً جعل الملك يرفض جلوسه معه. كما صور هذا الشعر نفور المجتمع الجاهلي من البرص، الذي لا يزال المجتمع العربي ينفر منه اليوم؛ لكن ربما كان في الجاهلية دليل نحس لعدم وجود الوعي العلمي والمعرفة الطبيّة، على حين أن الطب الحديث يعرّفه مرضاً يصيب الدم فيظهر على الجلد.
ومن الشعر ما يكون تهديداً وتلويحاً قريباً من التحريض. فقد يكون اختلاف الخلق بين فردين قريبين دافعاً لأحدهما للقول، وبيان السلبيات التي تضر بالقرابة فتفسدها وينتهي الأمر إلى التشهير والفتنة والعداء، ومن ثمة الحرب والقتال، كما في قول ذي الإصبع الْعَدْوَانِي( ) :
لِيَ ابنُ عَمٍّ على ما كان من خُلُق
مُخْتلِفَان فأقليه ويَقْليني( )
أَزْرَى بنا أنّنا شالَتْ تعامتُنا
فَخَاْلَني دُوْنَه وخِلْتُه دُوْنِي
يَا عمرو إلاّ تَدَعْ شَتْمي وَمَنْقَصَتي
أَضْرِبْكَ حتّى تقولَ الهامة اسْقُوْني
عنّي إليكَ فما أمّيَ براعِيَةٍ
ترعى الْمَخَاضَ، وما رَأْي بمَغْبُوني( )
وَأَنْتُمْ مَعْشَرٌ زِيْدٌ على مائةٍ
فاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ كُلاًّ فكِيْدوْني
لَوْ تَشْرَبُوْنَ دَمي لم يَرْوَ شاربكم
وَلاَ دِمَائَكُمْ جَمْعَاً تُرَوّيني
لا يُخْرِجُ الكرْهُ منّي غيرَ مَأْبِيَةٍ
وَلاَ أَلِيْنُ لِمَنْ لاَ يَبْتَغِي لِيْني
هذه القصيدة توقفنا على الحقيقة القبلية، فالعلاقات داخل القبيلة ليست قائمة على التأييد والتضامن دائماً. وهذا أقرب إلى الحقائق الاجتماعية في كل العصور. فابنا العم هنا يعيشان أعلى درجات البغضاء والحقد. وقد اختلفا اختلافاً فينا لدرجة جعلت ذا الإصبع يحكيه شعرا فينذره بالضرب حتى الموت ويعرّض به فيكشف لنا عن ازدراء الجاهليين لأبناء الإماء، ويرتفع مد العداء كأساً ترتوي به الأنفس.
وتخرج العداوة من إطار النزعة الفردية أحياناً، لا تنتشر في إطار جماعي مؤذٍ. كأن يحط شاعر قبيلة ما، من شأن كثير من القبائل مجتمعة فيؤلّب تلك القبائل على قومه. وأحياناً يفخر بقومه وبشدة بأسهم في الحرب على حساب قوم آخرين، يطعن بهم ويشكك في مقدرتهم، مما يولد لديهم حب الانتقام بدافع تكذيبه وبيان زيف قوله، فيكون أراد شيئاً، ولكنه حصد شيئاً آخر غير الذي أراده، وجلب الدمار على قبيلته.
ذهب ربيعة بن مقروم( ) إلى مثل هذا فذكر كثيراً من أيام العرب، كأيام بزاخة، والنسار، والطخفة، والكلاب، وذات السليم( ) . وافتخر بانتصار قومه على هوازن ومذحج، فقصد الحط من شأنهم والرفعة من شأن قومه،فقال( ) :
فدىً بِبُزَاخة أَهْلي لهم
إذَا مَلأَوا بالجمُوْع الحَزِيْمَا( )
وإذا لقيت عامِرٌ بالنِّسا
رِمِنْهُمُ وطَخْفَت يوماً غشوما
به شاطروا الحيَّ أموالهم
هوازِنَ ذا وَفْرِهَا والْعَدِيْمَا( )
وساقَتْ لنا مَذْحِجٌ بالكِلابِ
مواليَها كلَّها والصَّمِيْمَا( )
فَدَارَتْ رَحَانَاْ بفُرْسَانِهِمْ
فعَادوا، كَأَنْ لم يكونوا رِمَيْما
ولاشك أن هذا الشعر يخفف من الانتماء القومي العفوي. وأنه يصعد إحساس الشعراء من القبائل الأخرى بضرورة الرّد والدّفاع مما يقوي تيار التحريض والتفرق أيضاً.
وقد أصبح مجموع هذا الشعر تراثاً سلبياً للعرب المعاصرين، فخلافاتُهم الممتدة على طول الوطن وعرضه، ترتكز على قاعدةٍ من قواعد التراث وهي سلبية وحقيقة علميّة تؤكدها كتب علم النفس الإفرادي والجماعي. ومجموع هذا الشعر ولّد ما يُعْرَفُ بالنقائض. فَعَديّ ابن رعلاء الغساني( ) . يقول مثل قول ربيعة بن مقروم، فيحط ويرفع في معرض ذكر يوم (أباغ). وهو بين المنذر بن ماء السماء، وبين الحارث الأعرج بن ابي شعر جبلة، و سبب ذلك أن المنذر سار من الحيرة في معد كلها حتى نزل بـ (عين أباغ)، وأرسل إلى الحارث ملك العرب بالشام: "إما أن تعطيني الفدية فأنصرف عنك بجنودي، وإما أن تأذن بحرب، وكانت الحرب( ) "، فقال عدي( ) :
رُبّما ضَرْبَةْ بِسَيْفٍ صَقِيْل
دُوْنَ بُصْرى( ) وطَعْنَةٍ نَجْلاَءِ
وَغَمُوسٍ تَضِلُّ فيها يَدُ الآَ
سِي( ) ويَعْيَا طَبِيْبُهَا بالدَّوَاءِ
رَفَعُوا رايةَ الضِّرابِ وآلوْا
لَيَذُوْدُنَّ سامرَ الْمَلْحاءِ( )
فَصَبَرْنَ النّفوس للطّعنِ حتى
جَرت الخيلُ بَيْنَنَا في الدّمَاءِ
لَيْسَ من مَات فاسْتَراحَ بميّتٍ
إنّما الميتُ ميّتُ الأَحْيَاءِ
إنما الميّت من يعيش ذَلِيْلاً
سيئاً بَالُه قَلِيْل الرَّجَاءِ
أول ما يلفت النظر هنا هو أن ( أباغ) موضع بطرف العراق مما يلي الشام حيث أوقع الحارث، وهو يدين لقيصر الروم، بالمنذر وبعرب العراق وهم يدينون لكسرى.
وهذا يدل على تبعية القبائل العربية للدول الكبرى في ذلك الزمان، كما هو شأن كثير منها الآن. كما أنه حجة بيد من ينفي الشعور القومي العفوي عند العرب الجاهليين.
وهو من وجهة البحث التاريخية تخلف في لاوعي الاجتماعي والسياسي يأخذ شكل الموقف السلبي بين أبناء أرومة واحدة.
فقد كان أثر هذه القصائد سلبياً على المجتمعات العربية البدوية والحضرية. فمثل هذه القصيدة وما شاكلها فتيل كل معركة ووقود كل حرب ضحيتها كثير من الأبرياء.
كذلك مما يلفت النظر في هذه القصيدة البيتان الأخيران فقد قالهما في شأن من تدعه الحرب سليماً معافى في ثياب من الذل والخزي، فحياته ليس إلا موتاً. ومثل هذا القول يُنْثَرُ فوق رؤوسِ قَوْمٍ أُبَاةٍ يرفضون الحياة الذليلة الرخيصة، كفيل بدفعهم إلى القتال من جديد. ولكن البيتين حين سارا بعد ذلك مسير المثل والحكمة الخالدة لكل حياة رخيصة، صارا فثي المواقع الإيجابية المحمودة المعزّزَة لرفض الهوان. والخيط بين الموقعين رفيع.
وحين بعث الرسول كان أول من أدرك أثر هذه القصائد في هدم المجتمع العربي، فكان ينهي عن تعلم هذا النوع من الشعر، مثلما نهى الناس( ) عن تعلم قصيدة الشنفرى في مقاطعة آل غسان – إن صح الحديث – التي يقول منها( )
ما كلُّ يَوْمٍ ينالُ المرءُ ما طَلَبَا
وَلاَ يَسُوْغه المقدارُ مَا رَغِبَا
لاَ تَقْطَعن ذَنَبَ الأَفْعى وَتَتْركَها
إن كُنْتَ شَهْماً فَاتْبَعْ رَأْسَها الذَّنَبَا
همُ جرّدوا السَّيفَ فاجْعَلْهُمْ لـه جُزراً
وأَضْرَموا النّارَ فاجْعَلْهُم لَهَا حَطَبَا
وربّما كان هذا الحديث منحولاً انتحله آل غسان، ولكن الروح، العامة له توافق كثيراً من الأحاديث النبوية الأخرى التي تنهى عن إذاعة الغش.
والبيت الأول خلاصة تجارب الحياة، وكذلك الثاني، بل إنه لمن المفيد تعلم مثل هذا البيت فهو من الحكم الحربية التي يجب التقيد بها داخل المدارس العسكرية، فمن غير المعقول أن تضع الحرب أوزارها وتتصور أننا أحرزنا نصراً في معركة قتلنا فيها الذنب وتركنا الرأس المدبّر يسعى ثانية ليجمع فلوله مرة أخرى.
والبيت الثالث أيضاً لا نجد فيه ما يستوجب المنع، فمن يشعل نار الحرب لابد أن يصطلي بها. وأصبحنا ولا رؤية لنا في هذا القول إلا أنه منحول على رسول الله انتحله آل غسان دفاعاً عنها وعن عزها الجاهلي، وقد علم فاعله أن مفعول القصيدة في الإسلام باطل، ولكنه أراد أن يخلّص غساناً من أمر شين نسب إليها في جاهليتها حين عادة العصبية جَذِعةً أيام الأمويين. وهذا لا يمنع أن يكون الرسول قد حذر من تعلم شعر الفتن | |
|   | | | | الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام -تتمة1- |  |
|
مواضيع مماثلة |  |
|
| | صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|